فصل في اشتمال القرآن على أنواع الإعجاز .
وهو أن يقع التركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعنى .
وقد اختلف في أنه : هل تتفاوت فيه مراتب الفصاحة ؟ واختار القاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب ( الإعجاز ) المنع ، وأن كل كلمة موصوفة بالذروة العليا ، [ ص: 248 ] وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض ; وهذا كما أن بعضهم يفطن للوزن بخلاف بعض .
واختار أبو نصر بن القشيري في تفسيره التفاوت ، فقال : وقد رد على الزجاج ، وغيره تضعيفهم قراءة ( والأرحام ) بالجر : هذا من الكلام مردود عند أئمة الدين ; لأن القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت فمن رد ذلك ، فكأنما رد على النبوة ، وهذا مقام محذور ، لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو . ولعلهم أرادوا أنه [ ص: 249 ] صحيح فصيح ، وإن كان غيره أفصح منه ، قال : فإنا لا ندعي أن كل ما في القرآن على أرفع الدرجات في الفصاحة .
وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين في كتاب المجاز وأورد سؤالا فقال : فإن قلت : فلم لم يأت القرآن جميعه بالأفصح والأملح ؟ وقال : فيه إشكال يسر الله حله .
قال القاضي صدر الدين موهوب الجزري رحمه الله : وقد وقع لي حل هذا الإشكال بتوفيق الله تعالى ، فأقول : البارئ جلت قدرته له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره ، فإنه كان قادرا على إلجاء المشركين إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ( الشعراء : 4 ) ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب الأسباب والمسببات ، وجاري العوائد الواقعة من أهل الزمان ؛ ولذلك تكون حروب الأنبياء سجالا بينهم وبين الكفار ، ويبتدئ أمر الأنبياء بأسباب خفيفة ، ولا تزال تنمى وتشتد ، كل ذلك يدل على أن أساليبهم في الإرسال على ما هو المألوف والمعتاد من أحوال غيرهم .
إذا عرف ذلك كان مجيء القرآن العزيز بغير الأفصح والأملح جميعه ; لأنه تحداهم بمعارضته على المعتاد فلو وقع على غير المعتاد ، لكان ذلك نمطا غير النمط الذي أراده الله عز وجل في الإعجاز .
ولما كان الأمر على ما وصفنا جاء القرآن على نهج إنشائهم الخطب ، والأشعار وغيرها ، [ ص: 250 ] ليحصل لهم التمكن من المعارضة ثم يعجزوا عنها ، فيظهر الفلج بالحجة ; لأنهم لو لم يتمكنوا لكان لهم أن يقولوا : قد أتيت بما لا قدرة لنا عليه ; فكما لا يصح من أعمى معارضة المبصر في النظر لا يحسن من البصير أن يقول : غلبتك أيها الأعمى بنظري ; فإن للأعمى أن يقول : إنما تتم لك الغلبة لو كنت أنظر وكان نظرك أقوى من نظري ; فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح معنى المعارضة .
فإن قلت : فلو كانت المعجزة شيئا لا يقدر عليه البشر ، كإحياء الموتى وأمثاله ، فكيف كان ذلك أدعى إلى الانقياد ؟ .
قلت : هذا السؤال سبق الجواب عنه في الكلام ، وإن أساليب الأنبياء تقع على نهج أساليب غيرهم .
فإن قلت : فما ذكرته يدل على أن عجز العرب عن معارضته إنما كانت لصرف دعاويهم ، مع أن المعارضة كانت مقدورة لهم .
قلت : قد ذهب بعض العلماء إلى ذلك ، ولكن لا أراه حقا ، ويندفع السؤال المذكور . وإن كان الإعجاز في القرآن بأسلوبه الخاص به ; إلا أن الذين قالوا : بأن المعجز فيه هو الصرفة مذهبهم أن جميع أساليبه جميعا ليس على نهج أساليبهم ; ولكن شاركت أساليبهم في أشياء :
منها : أنه بلغتهم . ومنها : أن آحاد الكلمات قد كانوا يستعملونه في خطهم وأشعارهم ، ولكن تمتاز بأمور أخر ; منها غرابة نظمه الخاص الذي ليس مشابها لأجزاء الشعر وأوزانه وهزجه ورجزه وغير ذلك من ضروبه ; فأما توالي نظمه من أوله إلى آخره ، بأن يأتي بالأفصح والأملح ; فهذا مما وقعت فيه المشاركة لكلامهم ; فبذلك امتاز هذا المذهب عن مذهب من يقول : إنه كان جميعه مقدورا لهم ، وإنما صرفت دواعيهم عن المعارضة . انتهى .
وقد سبق اختيار القاضي أنه ليس على أساليبهم ألبتة فيبقى السؤال بحاله .
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية

البرهان في علوم القرآن
الزركشي - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي
- البرهان في علوم القرآن
- فصل في أنواع علوم القرآن
- النوع الثامن والثلاثون معرفة إعجازه
فصل في اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز
 صفحة
248
صفحة
248
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
 جزء
2
جزء
2
فَصْلٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28899_18626_28741اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنْوَاعِ الْإِعْجَازِ .
وَهُوَ أَنْ يَقَعَ التَّرْكِيبُ بِحَيْثُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُوجَدَ مَا هُوَ أَشَدُّ تَنَاسُبًا وَلَا اعْتِدَالًا فِي إِفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ : هَلْ تَتَفَاوَتُ فِيهِ مَرَاتِبُ الْفَصَاحَةِ ؟ وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=14628الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ فِي كِتَابِ ( الْإِعْجَازِ ) الْمَنْعَ ، وَأَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مَوْصُوفَةٌ بِالذِّرْوَةِ الْعُلْيَا ، [ ص: 248 ] وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ أَحْسَنَ إِحْسَاسًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ ; وَهَذَا كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَفْطِنُ لِلْوَزْنِ بِخِلَافِ بَعْضٍ .
وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=12851أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ التَّفَاوُتَ ، فَقَالَ : وَقَدْ رُدَّ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجِ ، وَغَيْرِهِ تَضْعِيفُهُمْ قِرَاءَةَ ( وَالْأَرْحَامِ ) بِالْجَرِّ : هَذَا مِنَ الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ ; لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29581_20756الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا ثَبَتَ فَمَنْ رَدَّ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّمَا رَدَّ عَلَى النُّبُوَّةِ ، وَهَذَا مَقَامٌ مَحْذُورٌ ، لَا يُقَلَّدُ فِيهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ . وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ [ ص: 249 ] صَحِيحٌ فَصِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْصَحَ مِنْهُ ، قَالَ : فَإِنَّا لَا نَدَّعِي أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْفَصَاحَةِ .
وَإِلَى هَذَا نَحَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ وَأَوْرَدَ سُؤَالًا فَقَالَ : فَإِنْ قُلْتَ : فَلِمَ لَمْ يَأْتِ الْقُرْآنُ جَمِيعُهُ بِالْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ ؟ وَقَالَ : فِيهِ إِشْكَالٌ يَسَّرَ اللَّهُ حَلَّهُ .
قَالَ الْقَاضِي صَدْرُ الدِّينِ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ وَقَعَ لِي حَلُّ هَذَا الْإِشْكَالِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَقُولُ : الْبَارِئُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ لَهُ أَسَالِيبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى مَجَارِي تَصْرِيفِ أَقْدَارِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى إِلْجَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِقْرَارِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ( الشُّعَرَاءِ : 4 ) وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ عَلَى أَسَالِيبِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ ، وَجَارِي الْعَوَائِدِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ ؛ وَلِذَلِكَ تَكُونُ حُرُوبُ الْأَنْبِيَاءِ سِجَالًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ ، وَيَبْتَدِئُ أَمْرُ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْبَابٍ خَفِيفَةٍ ، وَلَا تَزَالُ تُنَمَّى وَتَشْتَدُّ ، كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَسَالِيبَهُمْ فِي الْإِرْسَالِ عَلَى مَا هُوَ الْمَأْلُوفُ وَالْمُعْتَادُ مِنْ أَحْوَالِ غَيْرِهِمْ .
إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ كَانَ مَجِيءُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِغَيْرِ الْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ جَمِيعِهِ ; لِأَنَّهُ تَحَدَّاهُمْ بِمُعَارَضَتِهِ عَلَى الْمُعْتَادِ فَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَادِ ، لَكَانَ ذَلِكَ نَمَطًا غَيْرَ النَّمَطِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِعْجَازِ .
وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا جَاءَ الْقُرْآنُ عَلَى نَهْجِ إِنْشَائِهِمُ الْخُطَبَ ، وَالْأَشْعَارَ وَغَيْرَهَا ، [ ص: 250 ] لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ ثُمَّ يَعْجِزُوا عَنْهَا ، فَيَظْهَرَ الْفَلْجُ بِالْحُجَّةِ ; لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا لَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : قَدْ أَتَيْتَ بِمَا لَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَيْهِ ; فَكَمَا لَا يَصِحُّ مِنْ أَعْمًى مُعَارَضَةُ الْمُبْصِرِ فِي النَّظَرِ لَا يَحْسُنُ مِنَ الْبَصِيرِ أَنْ يَقُولَ : غَلَبْتُكَ أَيُّهَا الْأَعْمَى بِنَظَرِي ; فَإِنَّ لِلْأَعْمَى أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا تَتِمُّ لَكَ الْغَلَبَةُ لَوْ كُنْتُ أَنْظُرُ وَكَانَ نَظَرُكَ أَقْوَى مِنْ نَظَرِي ; فَأَمَّا إِذَا فُقِدَ أَصْلُ النَّظَرِ فَكَيْفَ تَصِحُّ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ .
فَإِنْ قُلْتَ : فَلَوْ كَانَتِ الْمُعْجِزَةُ شَيْئًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَأَمْثَالِهِ ، فَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الِانْقِيَادِ ؟ .
قُلْتُ : هَذَا السُّؤَالُ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنَّ أَسَالِيبَ الْأَنْبِيَاءِ تَقَعُ عَلَى نَهْجِ أَسَالِيبِ غَيْرِهِمْ .
فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا ذَكَرْتَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَجْزَ الْعَرَبِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ لِصَرْفِ دَعَاوِيهِمْ ، مَعَ أَنَّ الْمُعَارَضَةَ كَانَتْ مَقْدُورَةً لَهُمْ .
قُلْتُ : قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا أَرَاهُ حَقًّا ، وَيَنْدَفِعُ السُّؤَالُ الْمَذْكُورُ . وَإِنْ كَانَ الْإِعْجَازُ فِي الْقُرْآنِ بِأُسْلُوبِهِ الْخَاصِّ بِهِ ; إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا : بِأَنَّ الْمُعْجِزَ فِيهِ هُوَ الصَّرْفَةُ مَذْهَبُهُمْ أَنَّ جَمِيعَ أَسَالِيبِهِ جَمِيعًا لَيْسَ عَلَى نَهْجِ أَسَالِيبِهِمْ ; وَلَكِنْ شَارَكَتْ أَسَالِيبَهُمْ فِي أَشْيَاءَ :
مِنْهَا : أَنَّهُ بِلُغَتِهِمْ . وَمِنْهَا : أَنَّ آحَادَ الْكَلِمَاتِ قَدْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي خَطِّهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ ، وَلَكِنْ تَمْتَازُ بِأُمُورٍ أُخَرَ ; مِنْهَا غَرَابَةُ نَظْمِهِ الْخَاصِّ الَّذِي لَيْسَ مُشَابِهًا لِأَجْزَاءِ الشِّعْرِ وَأَوْزَانِهِ وَهَزَجِهِ وَرَجَزِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِهِ ; فَأَمَّا تَوَالِي نَظْمِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ ; فَهَذَا مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ لِكَلَامِهِمْ ; فَبِذَلِكَ امْتَازَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ كَانَ جَمِيعُهُ مَقْدُورًا لَهُمْ ، وَإِنَّمَا صُرِفَتْ دَوَاعِيهِمْ عَنِ الْمُعَارَضَةِ . انْتَهَى .
وَقَدْ سَبَقَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَسَالِيبِهِمْ أَلْبَتَّةَ فَيَبْقَى السُّؤَالُ بِحَالِهِ .
وَهُوَ أَنْ يَقَعَ التَّرْكِيبُ بِحَيْثُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُوجَدَ مَا هُوَ أَشَدُّ تَنَاسُبًا وَلَا اعْتِدَالًا فِي إِفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ : هَلْ تَتَفَاوَتُ فِيهِ مَرَاتِبُ الْفَصَاحَةِ ؟ وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=14628الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ فِي كِتَابِ ( الْإِعْجَازِ ) الْمَنْعَ ، وَأَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مَوْصُوفَةٌ بِالذِّرْوَةِ الْعُلْيَا ، [ ص: 248 ] وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ أَحْسَنَ إِحْسَاسًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ ; وَهَذَا كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَفْطِنُ لِلْوَزْنِ بِخِلَافِ بَعْضٍ .
وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=12851أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ التَّفَاوُتَ ، فَقَالَ : وَقَدْ رُدَّ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجِ ، وَغَيْرِهِ تَضْعِيفُهُمْ قِرَاءَةَ ( وَالْأَرْحَامِ ) بِالْجَرِّ : هَذَا مِنَ الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ ; لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29581_20756الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا ثَبَتَ فَمَنْ رَدَّ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّمَا رَدَّ عَلَى النُّبُوَّةِ ، وَهَذَا مَقَامٌ مَحْذُورٌ ، لَا يُقَلَّدُ فِيهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ . وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ [ ص: 249 ] صَحِيحٌ فَصِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْصَحَ مِنْهُ ، قَالَ : فَإِنَّا لَا نَدَّعِي أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْفَصَاحَةِ .
وَإِلَى هَذَا نَحَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ وَأَوْرَدَ سُؤَالًا فَقَالَ : فَإِنْ قُلْتَ : فَلِمَ لَمْ يَأْتِ الْقُرْآنُ جَمِيعُهُ بِالْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ ؟ وَقَالَ : فِيهِ إِشْكَالٌ يَسَّرَ اللَّهُ حَلَّهُ .
قَالَ الْقَاضِي صَدْرُ الدِّينِ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ وَقَعَ لِي حَلُّ هَذَا الْإِشْكَالِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَقُولُ : الْبَارِئُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ لَهُ أَسَالِيبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى مَجَارِي تَصْرِيفِ أَقْدَارِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى إِلْجَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِقْرَارِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ( الشُّعَرَاءِ : 4 ) وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ عَلَى أَسَالِيبِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ ، وَجَارِي الْعَوَائِدِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ ؛ وَلِذَلِكَ تَكُونُ حُرُوبُ الْأَنْبِيَاءِ سِجَالًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ ، وَيَبْتَدِئُ أَمْرُ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْبَابٍ خَفِيفَةٍ ، وَلَا تَزَالُ تُنَمَّى وَتَشْتَدُّ ، كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَسَالِيبَهُمْ فِي الْإِرْسَالِ عَلَى مَا هُوَ الْمَأْلُوفُ وَالْمُعْتَادُ مِنْ أَحْوَالِ غَيْرِهِمْ .
إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ كَانَ مَجِيءُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِغَيْرِ الْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ جَمِيعِهِ ; لِأَنَّهُ تَحَدَّاهُمْ بِمُعَارَضَتِهِ عَلَى الْمُعْتَادِ فَلَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَادِ ، لَكَانَ ذَلِكَ نَمَطًا غَيْرَ النَّمَطِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِعْجَازِ .
وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا جَاءَ الْقُرْآنُ عَلَى نَهْجِ إِنْشَائِهِمُ الْخُطَبَ ، وَالْأَشْعَارَ وَغَيْرَهَا ، [ ص: 250 ] لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ ثُمَّ يَعْجِزُوا عَنْهَا ، فَيَظْهَرَ الْفَلْجُ بِالْحُجَّةِ ; لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا لَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : قَدْ أَتَيْتَ بِمَا لَا قُدْرَةَ لَنَا عَلَيْهِ ; فَكَمَا لَا يَصِحُّ مِنْ أَعْمًى مُعَارَضَةُ الْمُبْصِرِ فِي النَّظَرِ لَا يَحْسُنُ مِنَ الْبَصِيرِ أَنْ يَقُولَ : غَلَبْتُكَ أَيُّهَا الْأَعْمَى بِنَظَرِي ; فَإِنَّ لِلْأَعْمَى أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا تَتِمُّ لَكَ الْغَلَبَةُ لَوْ كُنْتُ أَنْظُرُ وَكَانَ نَظَرُكَ أَقْوَى مِنْ نَظَرِي ; فَأَمَّا إِذَا فُقِدَ أَصْلُ النَّظَرِ فَكَيْفَ تَصِحُّ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ .
فَإِنْ قُلْتَ : فَلَوْ كَانَتِ الْمُعْجِزَةُ شَيْئًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَأَمْثَالِهِ ، فَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الِانْقِيَادِ ؟ .
قُلْتُ : هَذَا السُّؤَالُ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنَّ أَسَالِيبَ الْأَنْبِيَاءِ تَقَعُ عَلَى نَهْجِ أَسَالِيبِ غَيْرِهِمْ .
فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا ذَكَرْتَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَجْزَ الْعَرَبِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ لِصَرْفِ دَعَاوِيهِمْ ، مَعَ أَنَّ الْمُعَارَضَةَ كَانَتْ مَقْدُورَةً لَهُمْ .
قُلْتُ : قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا أَرَاهُ حَقًّا ، وَيَنْدَفِعُ السُّؤَالُ الْمَذْكُورُ . وَإِنْ كَانَ الْإِعْجَازُ فِي الْقُرْآنِ بِأُسْلُوبِهِ الْخَاصِّ بِهِ ; إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا : بِأَنَّ الْمُعْجِزَ فِيهِ هُوَ الصَّرْفَةُ مَذْهَبُهُمْ أَنَّ جَمِيعَ أَسَالِيبِهِ جَمِيعًا لَيْسَ عَلَى نَهْجِ أَسَالِيبِهِمْ ; وَلَكِنْ شَارَكَتْ أَسَالِيبَهُمْ فِي أَشْيَاءَ :
مِنْهَا : أَنَّهُ بِلُغَتِهِمْ . وَمِنْهَا : أَنَّ آحَادَ الْكَلِمَاتِ قَدْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي خَطِّهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ ، وَلَكِنْ تَمْتَازُ بِأُمُورٍ أُخَرَ ; مِنْهَا غَرَابَةُ نَظْمِهِ الْخَاصِّ الَّذِي لَيْسَ مُشَابِهًا لِأَجْزَاءِ الشِّعْرِ وَأَوْزَانِهِ وَهَزَجِهِ وَرَجَزِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِهِ ; فَأَمَّا تَوَالِي نَظْمِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْأَفْصَحِ وَالْأَمْلَحِ ; فَهَذَا مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُشَارَكَةُ لِكَلَامِهِمْ ; فَبِذَلِكَ امْتَازَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ كَانَ جَمِيعُهُ مَقْدُورًا لَهُمْ ، وَإِنَّمَا صُرِفَتْ دَوَاعِيهِمْ عَنِ الْمُعَارَضَةِ . انْتَهَى .
وَقَدْ سَبَقَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَسَالِيبِهِمْ أَلْبَتَّةَ فَيَبْقَى السُّؤَالُ بِحَالِهِ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
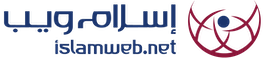
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام











 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات